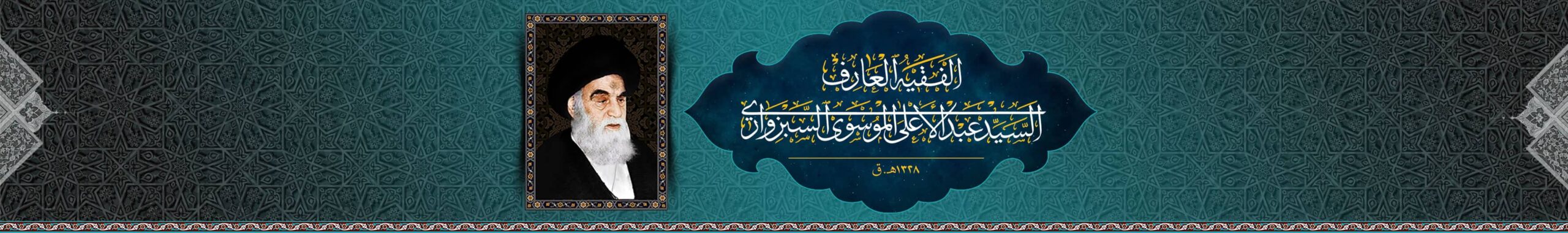و الأولان: التزام بعمل، أو ترك للّه تعالى على نحو خاص. و الأخير إخبار مؤكد بالقسم و يأتي الفصيل في محله.
في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين و يشترط في انعقادها: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار. فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشرا و قلنا بصحة عباداته و شرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه. و كذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهي، و السكران، و المكره (۱) و الأقوى صحتها من الكافر، وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض (۱) و خلافا للمشهور في النذر، وفاقا لبعض (۲)، و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر، و لا تتحقق القربة في الكافر، و فيه أولا: أنّ القربة لا تعتبر في النذر (۳)، بل هو مكروه (٤)، و إنّما تعتبر في متعلقه، حيث إنّ اللازم كونه راجحا شرعا (٥)، و ثانيا: إنّ متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات (٦)، و ثالثا: إنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا. و دعوى: عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة: بإمكان إسلامه ثمَّ إتيانه، فهو مقدور لمقدورية مقدّمته (۷)، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، و يعاقب على مخالفته، و يترتب عليها وجوب الكفارة، فيعاقب على تركها أيضا و إن أسلم صح إن أتى به، و يجب عليه الكفارة لو خالف و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام، لانصرافها عن المقام (۸). نعم، لو خالف و هو كافر، و تعلق به الكفارة فأسلم، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل (۹).
(مسألة ۱): ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و في انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله (عليه السلام): «لا يمين لولد مع والده» (۱۰)، و لا للزوجة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه»، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد. و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده. مع أنّه من الإيقاعات، و ادعى الاتفاق (1۱) على عدم جريان الفضولية فيها و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير- مثل الطلاق، و العتق، و نحوهما- لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه (1۲)، و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق. خصوصا إذا قلنا: إنّ الفضولي على القاعدة (۱۳) و ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن (۱٤) في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى: أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه: أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج و لازمه. جواز حلّهم له، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به. و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، و مع الإذن يلزم، و مع عدمهما ينعقد، و لهم حلّه و لا يبعد قوّة هذا القول: مع أنّ المقدر- كما يمكن أن يكون هو الوجود- يمكن أن يكون هو المنع و المعارضة، أي: لا يمين مع منع المولى، مثلا فمع عدم الظهور في الثاني، لا أقلّ من الإجمال (۱٥) و القدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحة و اللزوم. ثمَّ إنّ جواز الحلّ- أو التوقف على الإذن- ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا- كما هو ظاهر كلماتهم- (۱٦) بل إنّما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج، و كان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى. و أما ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده. و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة- مثلا- لا مانع من انعقاده، و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة، فالمراد من الأخبار: أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء. هذا كلّه في اليمين، و أما النذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضا و هو مشكل، لعدم الدليل عليه- خصوصا في الولد- الا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط و هو ممنوع (۱۷) أو بدعوى: أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر، لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها: خبران في كلام الإمام (عليه السلام) (۱۸). و منها: أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السلام) له (۱۹) و هو أيضا كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق (۲۰). نعم، في الزوجة و المملوك لا يبعد الإلحاق باليمين، لخبر قرب الإسناد عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر الا بإذن مولاه»، و صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها. إلا في حج، أو زكاة، أو بر والديها، أو صلة قرابتها» و ضعف الأول منجبر بالشهرة (۲۱) و اشتمال الثاني على ما نقول به لا يضرّ (۲۲) ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان (۲۳) و الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى (۲٤) بناءعلى اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يوجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج (۲٥)، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان (۲٦). ثمَّ على القول بأنّ لهم الحلّ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أو لا؟ وجهان (۲۷).
(مسألة ۲): إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف، و نفي السبيل (۲۸).
(مسألة ۳): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته (۲۹).
(مسألة ٤) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأم بالأب (۳۰).
(مسألة ٥): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمَّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه- بقي على لزومه (۳۱).
(مسألة ٦): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت، وجب عليها العمل به و إن كان منافيا للاستمتاع بها، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل، كالحج و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوجت بزيد (۳۲)- مثلا صامت كل خميس، و كان المفروض أنّ زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه و إن كان متأخرا في الإيقاع لأنّ حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها، فإنّه يوجب الصوم عليها، لأنّه متعلق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
(مسألة ۷): إذا نذر الحج من مكان معيّن- كبلدة أو بلد آخر معيّن- فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته و وجب عليه ثانيا (۳۳). نعم، لو عينه في سنة، فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة، لعدم إمكان التدارك، و لو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان، ثمَّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا، و خالف فحج من غير ذلك المكان، برئ من النذر الأول، و وجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني، كما أنّه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف، فإنّه يجزيه عن حجة الإسلام (۳٤) و وجب عليه الكفارة لخلف النذر.
(مسألة ۸): إذا نذر أن يحج و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت، فلا يجب عليه المبادرة (۳٥)، إلا إذا كان هناك انصراف،فلو مات قبل الإتيان به- في صورة جواز التأخير- لا يكون عاصيا. و القول بعصيانه- مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير- لا وجه له (۳٦). و إذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة (۳۷)، فلو أخر عصى، و عليه القضاء و الكفارة (۳۸)، و إذا مات وجب قضاؤه عنه، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات- بعد تمكنه منه، قبل إتيانه- وجب القضاء عنه (۳۹). و القول بعدم وجوبه، بدعوى: أنّ القضاء بفرض جديد، ضعيف لما يأتي (٤۰). و هل الواجب القضاء من أصل التركة، أو من الثلث؟ قولان،فذهب جماعة إلى القول بأنّه من الأصل، لأنّ الحج واجب ماليّ، و إجماعهم قائم على أنّ الواجبات المالية تخرج من الأصل. و ربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا، و إنّما هو أفعال مخصوصة بدنية و إن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته، كما أنّ الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك. و فيه أنّ الحج في الغالب محتاج إلى بذل المال، بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنية، فإن كان هناك إجماع و غيره على أنّ الواجبات المالية من الأصل يشمل الحج قطعا، و أجاب صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بأن المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا، و الحج كذلك، فليس تكليفا صرفا- كما في الصلاة و الصوم- بل للأمر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدّينية بخلاف سائر العبادات البدنية، فلذا يخرج من الأصل، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين، أو بمنزلة الدّين (٤۱) قلت: التحقيق أنّ جميع الواجبات الإلهية ديون للّه تعالى، سواء كانت مالا، أو عملا ماليا، أو عملا غير مالي، فالصلاة و الصوم أيضا ديون للّه، و لهما جهة وضع (٤۲) فذمة المكلّف مشغولة بهما، و لذا يجب قضاؤهما فإنّ القاضي يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت، و ليس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفارة، بل هو إتيان لما كانت الذمة مشغولة به (٤۳)، و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله «للّه عليّ أن أعطي زيدا درهما» دين إلهي لا خلقي (٤٤) فلا يكون الناذر مديونا لزيد، بل هو مديون للّه بدفع الدرهم لزيد، و لا فرق بينه و بين أن يقول: «للّه عليّ أن أحج أو أن أصلي ركعتين» فالكل دين اللّه (٤٥)، و دين اللّه أحق أن يقضي، كما في بعض الأخبار (٤٦). و لازم هذا كون الجميع من الأصل. نعم، إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه، و لا بعد موته سواء كان مالا أو عملا، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة فإنّه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته، و كما في نفقة الأرحام فإنّه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكنه لا يصير دينا عليه، لأنّ الواجب سدّ الخلة، و إذا فات لا يتدارك. فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكن و ترك حتّى مات وجوب قضائه من الأصل لأنّه دين إلهي (٤۷) إلا أن يقال: بانصراف الدّين عن مثل هذه الواجبات و هو محل منع (٤۸) بل دين اللّه أحق أن يقضى. و أما الجماعة (٤۹) القائلون: بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلوا بصحيحة ضريس، و صحيحة ابن أبي يعفور (۵۰) الدالتين على أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه، و إذا كان نذر الإحجاج كذلك- مع كونه ماليا قطعا- فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل و فيه: أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره (5۱)، و أما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض، بناء على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، و ربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات، و فيهما ما لا يخفى خصوصا الأول (5۲).
(مسألة ۹): إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة، و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره (5۳).
(مسألة ۱۰): إذا نذر الحج معلّقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة- فمات قبل حصول المعلق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة مبنية على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق (٥٤) فعلى الأول لا يجب (۵۵)، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، و إن كان متمكنا من حيث المال و سائر الشرائط، و على الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.
(مسألة ۱۱): إذا نذر الحج- و هو متمكن منه- فاستقر عليه، ثمَّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه، أو مصدودا بعدوّ أو نحوه- فالظاهر وجوب استنابته حال حياته، لما مرّ من الأخبار سابقا في وجوبها، و دعوى اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقا (۵۶) و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه و استقرار الحج عليه، أو نذر و هو مغصوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال، ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم (۵۷)، و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام إلا أن يكون قصده من قوله: «للّه عليّ أن أحج» الاستنابة (۵۸).
(مسألة ۱۲): لو نذر أن يحج راجلا في سنة معينة، فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة (۵۹)، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنّهما واجبان ماليان بلا إشكال (۶۰)، و الصحيحتان المشار إليهما سابقا- الدالتان على الخروج من الثلث- معرض عنهما- كما قيل- أو محمولتان على بعض المحامل (۶۱). و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا، أو معلقا على شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات، فإنّه يقضى عنه من أصل التركة (۶۲). و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلك (۶۳)، لأنّه واجب ماليّ أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر إنّه ما لم يتمكن معذور، و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنّه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال، كما إذا قال: «للّه عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم» و مات قبل تمكنه. و دعوى كشف عدم التمكن من عدم الانعقاد ممنوعة (6٤). ففرق بين إيجاب مال على نفسه، أو إيجاب عمل مباشريّ و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ دينا عليه بخلاف الأول (65).
(مسألة ۱۳): لو نذر الإحجاج معلقا على شرط- كمجيء المسافر أو شفاء المريض- فمات قبل حصول الشرط، مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه (66) إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّا حينه، و يدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى، فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه حيث قال الصادق (عليه السلام) بعد ما سئل عن هذا: «إنّ رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يحج عنه مما ترك أبوه» و قد عمل به جماعة و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيله سيد الرياض و قرّره عليه صاحب الجواهر، و قال: إنّ الحكم فيه تعبديّ على خلاف القاعدة.
(مسألة ۱٤): إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حج واحد (67)، و إذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته (68). و إذا قيّده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة (69)، و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا (70) و وجب عليه تحصيل الاستطاعة (71) مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة.
(مسألة ۱٥): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية (72) خلافا للدروس، و لا وجه له (73) إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا.
(مسألة ۱٦): إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد (7٤) إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت و يحتمل الصحة مع الإطلاق أيضا إذا زالت، حملا لنذره على الصحة.
(مسألة ۱۷): إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمَّ حصلت له، فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة الإسلام لفوريتها (75)، و إن كان مضيقا- بأن قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة، أو قيده بالفورية قدمه (76) و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت، و إلا، فلا، لأن المانع الشرعي كالعقلي (77) و يحتمل وجوب تقديم النذر (78) و لو مع كونه موسعا، لأنه دين عليه، بناء على ان الدين- و لو كان موسعا- يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر ان صرف استطاعته في حجة الإسلام.
(مسألة ۱۸): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه، وجب الإتيان به في العام القابل مقدما على حجة الإسلام (79) و إن بقيت الاستطاعة إليه، لوجوبه عليه فورا ففورا، فلا يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه. لكن عن الدروس انه قال- بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية- «فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلك إلى النذر (80)، فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضا» و لا وجه له (81). نعم، لو قيد نذره بسنة معينة، و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضا، لأن حجه النذري صار قضاء موسعا ففرق بين الإهمال مع الفورية و الإهمال مع التوقيت، بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذر موسعا.
(مسألة ۱۹): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان (82) فيكفي حج واحد عنهما، أو يجب التعدد، أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس؟ أقوال، أقواها الثاني، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب (83) و القول بأن الأصل هو التداخل ضعيف (8٤). و استدل للثالث بصحيحتي رفاعة و محمد بن مسلم (85): «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال (عليه السلام: نعم» و فيه: ان ظاهر هما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة، و هو غير معمول به و يمكن حملهما على انه نذر المشي لا الحج، ثمَّ أراد أن يحج، فسأل (عليه السلام) عن انه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بالكفاية. نعم، لو نذر أن يحج مطلقا- أي حج كان (86)- كفاه عن نذره حجة الإسلام بل الحج النيابي و غيره أيضا، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان (87).
(مسألة ۲۰): إذا نذر الحج- حال عدم الاستطاعة- معلقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام (88). و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق (89).
(مسألة ۲۱): إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما أما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا، أو التخيير، أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها وجوه، أوجهها الوسط، و أحوطها الأخير (90). و كذا إذا مات و عليه حجتان و لم تف تركته إلا لأحديهما و أما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما و لو في عام واحد (9۱).
(مسألة ۲۲): من عليها الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله (9۲).
(مسألة ۲۳): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا و إذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر، و لو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا (9۳) أيضا، لأن الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخير، و لا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان، و كان عاجزا عن بعض الخصال ثمَّ مات، فإنه يجب الإخراج عن تركته مخيرا و إن تعين عليه- في حال حياته- في إحديهما فلا يتعين في ذلك المتعين (9٤). نعم، لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا، و لم يتمكن من الآخر إلى إن مات، أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه بدعوى: ان النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه، بناء على ان عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد (95) و لكن الظاهر ان مسألة الخصال ليست كذلك، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في حياته متمكنا الا من البعض أصلا (96)، و ربما يحتمل- في الصورة المفروضة و نظائرها- عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا. بدعوى: ان متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير، و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا. بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر ان رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه، إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين. و فيه: ان مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا (97) حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما.
(مسألة ۲٤): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته و لو اختلف أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اجرة (98)، إلا إذا تبرع للوارث بالزائد، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد اجرة و إن جعل الميت أمر التعيين إليه (99) و لو أوصى باختيار الأزيد اجرة خرج الزائد من الثلث.
(مسألة ۲٥): إذا علم إن على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين و ليس عليه كفارة (100) و لو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا و حيث انها مرددة بين كفارة النذر و كفارة اليمين فلا بد من الاحتياط (101) و يكفي حينئذ إطعام ستين مسكينا، لأن فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف.
(مسألة ۲٦): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل، لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار (102)، و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه (103) و كذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا و لو مع الإغماض عن رجحان المشي، لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه. فما عن بعضهم: من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوى (10٤)، الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد، فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده.
(مسألة ۲۷): لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب (105)، و لا يجوز حينئذ (106) المشي و إن كان أفضل، لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده. نعم، لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد (107)، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا. و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين، و كذا ينعقد لو نذر الحج حافيا (108). و ما في صحيحة الحذاء، من أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّه حافية، قضية في واقعة، يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها، من إيجابه كشفها، أو تضررها أو غير ذلك (109).
(مسألة ۲۸): يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما، فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد (110). نعم، لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (111) هذا إذا كان حرجيا حين النذر، و كان عالما به (112) و أما إذا عرض الحرج بعد ذلك، فالظاهر كونه مسقطا للوجوب (113).
(مسألة ۲۹): في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدء الشروع في السفر، أو أفعال الحج أقوال (11٤). و الأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف (115)، و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّه علي أن أحج ماشيا»، و من حين الشروع في السفر إذا قال: «للّه علي أن أمشي إلى بيت اللّه» أو نحو ذلك (116) كما ان الأقوى ان منتهاه- مع عدم التعيين- رمي الجمار، لجملة من الأخبار (117) لا طواف النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات، كما في بعضالأخبار (118).
(مسألة ۳۰): لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره، و إن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره (119). كما انه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه، لخبر السكوني (120) و الأقوى عدم وجوبه، لضعف الخبر (121) عن إثبات الوجوب و التمسك بقاعدة الميسور لا وجه له (122) و على فرضه فالميسور و هو التحرك لا القيام (123).
(مسألة ۳۱): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا، فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة، و لا كفارة (12٤) إلا إذا تركها أيضا (125) و إن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفارة (126). و إذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء، لفوات محل النذر و الحج صحيح في جميع الصور (127). خصوصا الأخيرة (128) لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج و عدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة و قد يتخيل البطلان، من حيث ان المنوي- و هو الحج النذري- لم يقع، و غيره لم يقصد (129) فيه: ان الحج في حد نفسه مطلوب، و قد قصده في ضمن قصد النذر (130)، و هو كاف الا ترى أنه لو صام أياما بقصد الكفارة ثمَّ ترك السابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا، و انما تبطل من حيث كونها صيام كفارة و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا. و قد يستدل للبطلان- إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال- بأن الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا. و فيه منع كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده و منع استلزامه البطلان على القول به. مع انه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا، من غير تقييد بسنة معينة و لا بالفورية لبقاء محل الإعادة.
(مسألة ۳۲): لو ركب بعضا و مشي بعضها فهو كما لو ركب الكل، لعدم الإتيان بالمنذور (13۱)، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب، ضعيف لا وجه له (13۲).
(مسألة ۳۳): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه، أو رجائه (133) سقط. و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا، بل يسقط أيضا؟ فيه أقوال: أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة (13٤). الثاني: وجوبه بلا سياق (135). الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة. أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك، و توقع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس (136). الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة، أو اليأس في صورة الإطلاق، و توقع المكنة مع عدم اليأس (137). الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام (138) و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، و توقع المكنة مع الإطلاق و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث (139) إلا ان الأقوى- بملاحظة جملة من الأخبار- هو القول الثاني، بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدى، على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان (140)، مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه (141) من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده، و قبل الدخول في الإحرام أو بعده و من غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة، مع توقع المكنة و عدمه (142) و إن كان الأحوط في صورة الإطلاق- مع عدم اليأس من المكنة، و كونه قبل الشروع في الذهاب- الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة (143). و الأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة، مضافا إلى الخبر: «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حاجا قال (عليه السلام) فإذا تعب فليركب» و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حد العجز (1٤٤). و في مرسل حريز: «إذا حلف الرجل أن لا يركب، أو نذر أن لا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب».
(مسألة ۳٤): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض، أو خوف، أو عدو، أو نحو ذلك- فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر، أولا (145) لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان (146) و لا يبعد التفصيل (147) بين المرض و مثل العدو، باختيار الأول في الأول و الثاني في الثاني. و إن كان الأحوط الإلحاق مطلقا.
- الوسائل باب: ٥۸ من أبواب جهاد النفس حديث: 4.
- تقدم في صفحة: ۲۰.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب النذر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب النذر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب النذر حديث: ۲.
- سورة المائدة، الآية: ۲۷.
- تقدم في صفحة: ۱٥٤- ۱٥٥
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب اليمين حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب اليمين حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب العتق.
- ورد مضمونه في الوسائل باب: ۲۸ من أبواب أحكام العقود.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب اليمين حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب النذر حديث: 4.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب النذر حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب النذر حديث: 4.
- سورة النساء، الآية: ۱4۱.
- تقدم في صفحة: ۱۱- ۱۲.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب وجوب الحج حديث: 4.
- سورة آل عمران، الآية: ۹۷.
- راجع ج: ۷ صفحة: ۳۳۹.
- راجع ج: ۷ صفحة: ۳۳۹.
- تقدمت في ج: ۷ صفحة: ۳۳۹.
- تقدمت في ج: ۷ صفحة: ۳۳۹.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب النذر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب وجوب الحج حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب وجوب الحج حديث: ۱۰.
- لوسائل باب: ۳٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب النذر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب وجوب الحج حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب وجوب الحج حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب وجوب الحج حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۳4 من أبواب وجوب الحج حديث: ٦.
- تقدم في صفحة: ۲۱۹.